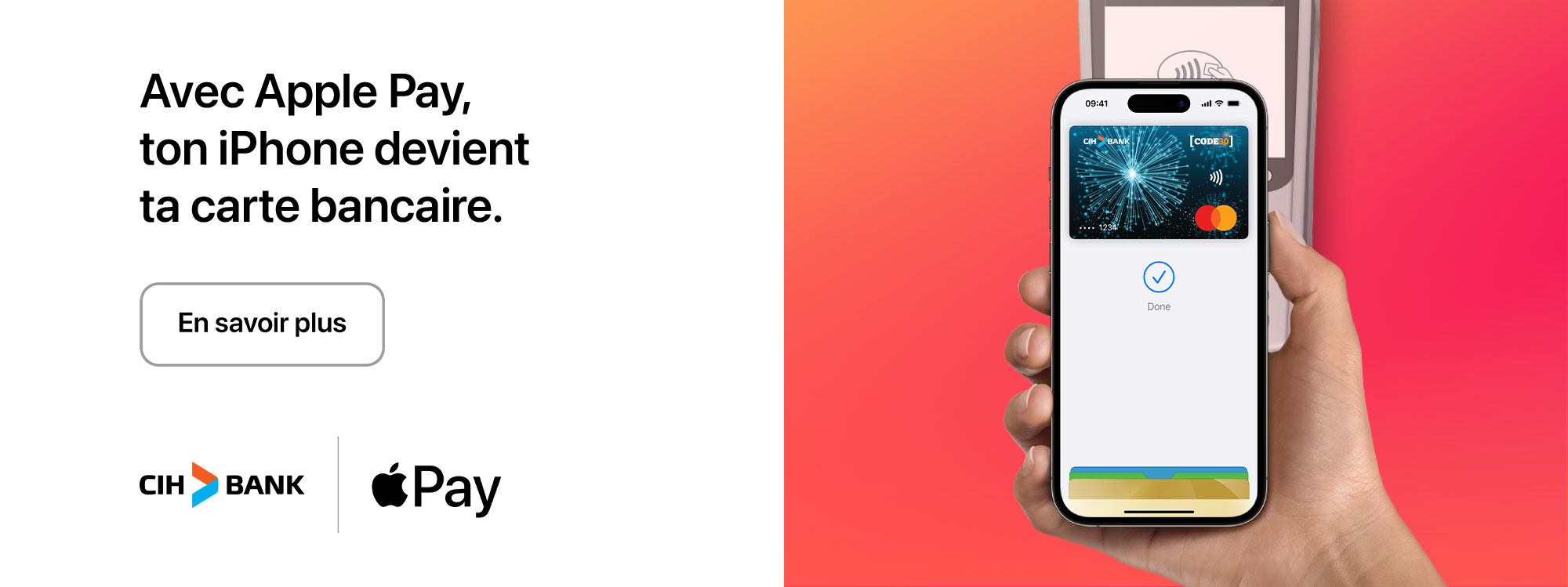شعيرة رمضان في الأشعار بين الإخفاء والإشهار

محمد بودويك
لا يختلف اثنان في أن الديانة الإسلامية، بما هي ديانة وحدانية سماوية مثل الديانتين الوحدانيتين الأُخْرَيَيْن: الديانة اليهودية، والديانة المسيحية ـ قامت، بالأساس، على ركائز وأعمدة وأسس هي ما أبقاها وخلدها، ومنحها دهرية متمددة ما تمدد الكون، وعمَّره الإنسان. أما تلك الركائز والأسس فليست غير العقائد والشرائع، والعبادات والمعاملات؛ فضلا عن الوصايا والمواعظ، والإرشادات. فكيف لرسالة سماوية أو “أرضية ” ـ في بعض الاعتبار ـ أن لا تقوم على ذلك، وعليه وَكْدُها وبنيانها وغايتها التي هي الخلائق والكائنات الحية العارفة المدركة المسؤولة عما تأتيه وما تقوله، وما تفعله، وما تعمله؟.
إن الأركان الركينة، والشعائر المكينة التي بها قوام الإنسان المؤمن العابد المتدين، الوَجِل الذي يخشى العقاب، ويرغب في الأجر والثواب، هي عماد الدين أي دين شرعه الحق الباري، أو شرعته الحكمة الإنسانية المستقطرة من تجربة روحية غنوصية هائلة، وخبرة حياتية عميقة بلا قرار اقتضتها العزلة الذهبية المثمرة، والتأمل الفكري الفلسفي والميتافيزيقي. ومن هنا، لا مشَّاحة في الدين الوحداني الذي شرعته القدرة الإلهية في سياقات اجتماعية وتاريخية وإنسانية ملتبسة، هيمن عليها الشر، وسادها التغول والقتل، وتوزيع الأدوار التي رفعت قلةً، ووضعت كثرة، واستشرت فيها العبودية والعبادة: عبودية الإنسان للإنسان، وعبادة المغلوب المعدم للغالب المالك كل شيء سرقة ونهبا وغصبا. ففي تلك الأزمنة التاريخية الغابرة والقريبة التي غَشِيَها ما غشيها من ظلم وجور، واستحوذ على الخلائق ما استحوذ من مروق وتوثين وتصنيم، بزغت أنوار الرسائل السماوية، رسائل الهدى التي دعت إلى السبل الأقوم: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.. ـ سورة الإسراء، الآية 9). وللغاية عينها نزلت التوراة، ونزل الإنجيل أو ما سمي بالعهدين: العهد القديم، والعهد الجديد.
ولسنا في مجال الحديث عن صحة ما نقرأ اليوم في العهدين، من عدمه؛ فذلك مقام آخر لا تفكر فيه هذه الورقة. وإذا كانت أركان الإسلام تخصيصا دارت على التشهد والصلاة والصوم والزكاة والحج، فلأن الشعائر إياها كانت منتشرة بهذا القدر أو ذاك في شبه الجزيرة العربية، ما خلا التشهد بوحدانية الله، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ إذْ إن الصلاة والصوم والزكاة والحج كُنَّ معهودات، ومورسن وإنْ بشكل مختلف كليا عما جاء به الإسلام مُدَقِّقا منظما، داعيا إلى القيام به وممارسته. فلْنقلْ إن الدين لم يقطع نهائيا مع شعائر “دينية” وثنية كانت معروفة ومتواترة في الحجاز وأطراف الحجاز، وفي غيره من جغرافيات الكون؛ ذلك أن القطائع الحادة تعود بالإنسان إلى نقطة الصفر، إلى بدء نشوئه وتكوينه، وتفرض على الرسل والأنبياء معاناة أكبر، ومكابدة أمض وأعسر، وضنكا لا عهد لهم به، كي يقنعوا ويملؤوا أذهانا شبت على رواسب ودفائن، ومأثورات ومواريث، بالجديد الخالص، والفكر المحض، والأحكام القشيبة، والعقائد والشرائع التي لا سند لها ماضيا، ولا خيط رابطا بالآباء والأولين، ولو كان واهناً.
ومع ذلك، وكما نعلم، دارت الدوائر على الأنبياء والرسل والحكماء، مثلما دارت على الفلاسفة وعلماء الكلام، والمتصوفة على مستوى آخرَ. لأن الإنسان عدو ما يجهله بالفطرة، فهو لا يَني يقاوم بكل ما أوتي من شراسة ومكر، وتقية، كل غريب ودخيل ومباغت. ومن ثَمَّ، لم تركز الرسالة الوحدانية لواءها على أرض صلبة خصبة، غامزة عامرة بشهي الثمار، ومبهر النتائج والحصائل، إلا بعد أن جاهد الرسول الأكرم الجهادين: الأصغر والأكبر، وأَعْمَل اللين والحكمة والحسنى والتسامح تارةً، كما أعمل النفي والسيف والمطاردة طورا آخر. وما عتم أن رفرف اللواء العريض الوسيع عاليا، واستتب الأمن والظفر شاهقا ومحيطا، وتمكنت حِكَم ُوأفكار ووصايا الدعوة تمكنا من نفوس المسلمين إلى يوم الناس هذا؛ فصارت رَكْبا في الرّكاب، وظلا في الظلال، وشمسا بين أيدي المؤمنين يعملون بها، ويمارسونها، ويرفعون عُمُدَها وطُنُبَها في العالمين: في كل الأمصار والبقاع التي بلغها صهيل الخيول، وصليل الأحسمة والسيوف، وشعيرة الوحدانية والتشهد.
ولئن كان رمضان أحد الشعائر الأكثر حرمة وقداسة وبركة وتبريكا، والمفضل على باقي الشهور، بل على باقي الأركان والشعائر الأخرى،، فلأنه لله لا للعبد الصائم: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به). وإلى جانب الحديث القدسي هذا، وردت أفضليته مضمرةً في الآية الكريمة التالية: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ـ سورة البقرة ـ الآية 185 ). فأي فضل بقي للأشهر الأخرى، والحال أن الكتاب الأول، النص الأعظم الذي هو القرآن، نزل في شهر رمضان؟ وإذا كان شهر رمضان يوحي ـ بدليل لغته ومعناه ـ بالصبر والمجاهدة والتضحية من إمساك عن شهوتي البطن والفرج، وغيبة اللسان، والالتفات إلى أوضاع السائلين المحرومين، الفقراء المحتاجين (وإنْ كان في الأمرـ راهنا ـ نظرٌ) فإن ما ورد في القرآن، وما تواتر من أحاديث نبوية في الصحيحين، يفيد بالترخص ورفع الحرج في مسائل تتعلق بتناول الأدوية والطعام للمصابين بالأمراض المزمنة وغير المزمنة، والضاربين في الأرض سفرا وبحثا مضنيا عن العمل؛ وما يتصل بمواقف حميمة خاصة تبيح ملامسة الزوجة ملامسة خفيفة، وتقبيلها ومداعبتها ضمن حدود معقولة فيها كبح وتحكم وفرملة للشهوتين: شهوة الرجل التي ينطق بها الإنعاظ، وشهوة المرأة التي ينطق بها غنجها وتكسرها. لكن، هل في مُكْنَة الإنسان الشهوي بطبعه الذي خسر أبوه الأعلى آدم الجنة لأن سوْءَتَه وسوءَة حواء بدتا فحركتا دبيب دمهما، وأشعلتا النار في جسميهما؟. وإذاً، فالإنسان وارث الشهوة، يُمَغْنِطُه الجسد، ويستعبده الحس، وتُطَوِّح به الوَحْوَحَة.
وقد سألني أحد طلبتي، وفي سؤاله حيرة واستغراب وشبه استنكار: هاتِ ما عندك من أشعار قيلت في الشهر الفضيل لعلها تشفي غليلي أكثر، وتضيف فضلا إلى فضل مركوز؟ وقد وقفت مشدوها بدوري أمام مفاجأة السؤال، وحِرْتُ في ما ينبغي أن أجيبه به، وأقنعه بأن الفراغ سيدٌ في هذا الباب، باب الشعر تحديدا: القديم والجديد لدى شعرائنا العرب المسلمين الكبار في أحقاب وأعصر مختلفات كشعراء النقائض، وأبي نواس، وأبي العتاهية، وابن الرومي، وصريع الغواني، وبشار بن برد، وأبو تمام والبحتري، والمتنبي والمعري.. وصولا إلى شعرائنا العموديين المعاصرين الأفذاذ كأحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، ومحمد مهدي الجواهري، وبدوي الجبل، وعمر أبو ريشة.. الخ. ألم يقل أحمد شوقي غفر الله له: رَمَضانُ وَلَّى هاتِها يا ساقي مُشتاقةً تسعى إلى مشتاقِ
ما كانَ أكثَرَهُ على أُلاَّفــهـا وأقلَّه في طاعة الخلاّق
لكنني زخرفتُ ردي مقتنعا أو غير مقتنع بالقول: إن عظمة الشهر وبركته وجلاله دينيا وإيمانيا وتعبديا وخشوعا أملى عليهم الصمت البليغ، إذ لو تكلموا وصاغوا أقاويلهم الشعرية فيه ما ظفروا قُلاَمة ظُفْر بشأو شعري، ولا بحبة خَرْدل مما رغبوا فيه. زخرفتُ القول مستنجدا بما أوثرَ عن قول الشاعر المخضرم (الجاهلي ـ الإسلامي )، الفحل لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة الذائعة:
عَفَتِ الديار محلُّها فمُقامُها بمِنىً تأبد غَوْلُها فرِجامُها
فمدافِعُ الريَّان عُرّيَ رسمُها خَلَقاَ كما ضَمِنَ الوُحَيُّ سِلامُها
من أنه رد على طلب الخليفة عمر بن الخطاب: (أنْشِدْني من شعرك )، بقوله: “كيف أقول شعرا وقد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران؟”، فهل يكون شيطانهم، شيطان الشعر قد هجرهم في أمر الدين، وخلال شهر رمضان، لأنهم لا يُرَقِّصونه ولا تهتز أعطافه، وقرون استشعاره لشعرهم إلا وهم آكلون شاربون بالمعنيين: شرب الماء، وشرب الراح؟.
وبناءً عليه، أيكونُ سكوت الشعراء الكبار الذين ذكرناهم وآخرين غيرهم، الذين ملؤوا الدنيا، وشغلوا الناس في العصور الخوالي والتوالي، عن مدح الرسول العظيم، من قبيل ما ذكرناه عن سكوتهم في مدح رمضان؟.
ذلك ما سأقاربه ـ بعون الله ـ في المقالة القادمة.