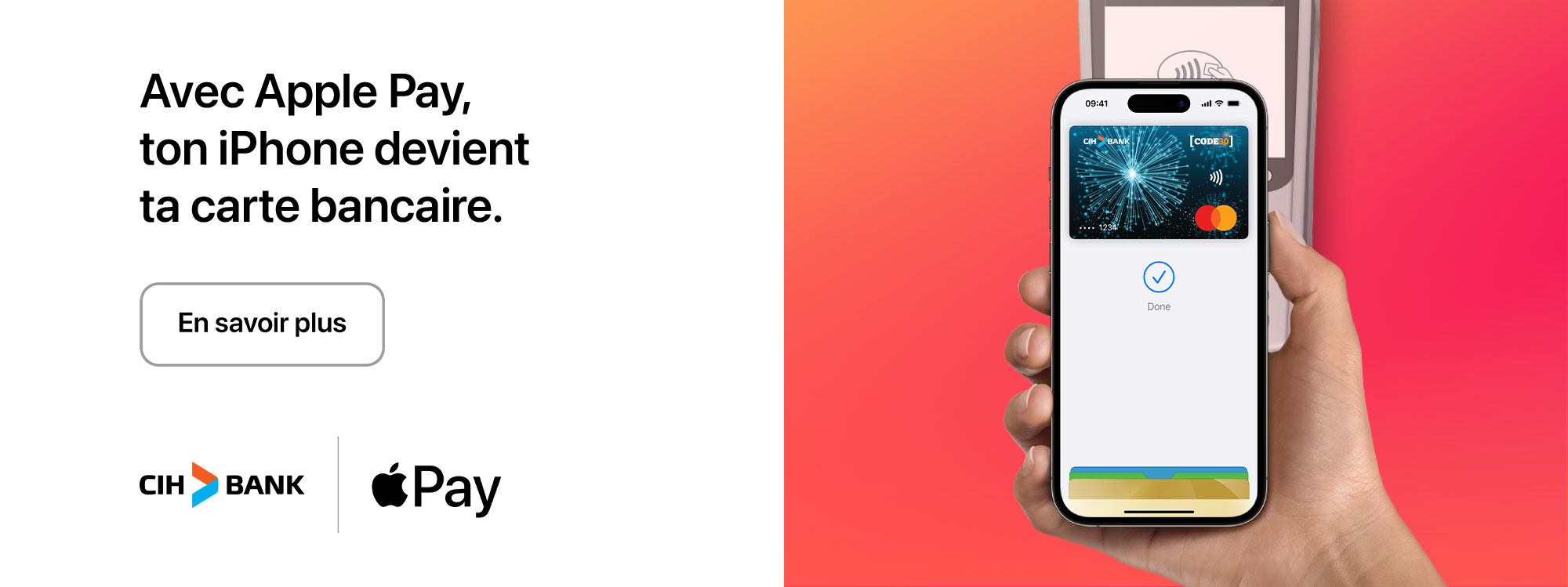أسرار كورونا.. هل خسرت البشرية حربها ضد “الفيروسات”؟

الرباط اليوم
هل خسرت البشرية حربها ضد “الفيروسات”؟ فالعالم يتجه صراحة إلى حقبة ما بعد المضادات الحيوية، حقبة يمكن خلالها للإصابات البسيطة والعدوى المعتادة التي كان علاجها سهلا على مدى عقود أن تقتل.. ” هذا ما خلص إليه الدكتور المختص في الأمراض المعدية كيجي فوكوكدا في تقرير منظمة الصحة العالمية الأول حول خطورة الأزمة الصحية في العالم في 2014.
وربما هذا ما يفكر فيه كثير من الأطباء والمختصين في سياق أزمة انتشار فيروس “كورونا” المسبب لمرض “كوفيد 19”. وبينما تتجاوز أعداد الإصابات عشرات الآلاف ويواصل الفيروس انتشاره عبر مختلف دول العالم، وحصد المزيد من الوفيات خصوصا في القارة العجوز، تعود حكاية الصراع القديم الجديد بين المناعة البشرية والبكتيريات والفيروسات.
وبما أن الفيروسات قد ظلت دائما عدوا حقيقيا يهدد حياة الإنسان، في ظل اعتماده في الغالب على مناعته لمواجهتها، في غياب العلاجات الفعالة، فإن المعركة الأخرى الموازية ضد البكتيريا ربما فتحت على الإنسان أبواب جهنم وضربته في مقتل من حيث لا يدري. هذه المشكلة التي أضحت مطروحة بقوة في السنوات الأخيرة وأضحى العلماء يحذرون من مغبتها، تتمثل في ظهور المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية التي طورتها مؤخرا بعض أنواع من البكتيريا، خاصة تلك المسببة لأمراض غاية في الخطورة كالسل والالتهاب الرئوي، أو التهابات المسالك البولية والإسهال.
فالسل المقاوم للمضادات الحيوية مثلا يقتل 480 ألف شخص سنويا وتلك بالفعل أزمة كبيرة، لكن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الإنسان هنا، هو عجزه خلال الثلاثين عاما الماضية عن صد هجمات أمراض مثل السل عادت للظهور.
لقد أصدرت منظمة الصحة العالمية نشرتها عن التقرير الجديد الخاص بنتائج متابعتها للتطورات الأخيرة في خطوط ابتكار المضادات الحيوية الجديدة في العالم، خاصة تلك التي من المفترض أن تُستخدم لعلاج مجموعات من البكتيريا كانت المنظمة قد صنفتها تحت قائمة “الأكثر خطورة” التي تتخذ الأولوية في البحث العلمي، كـ المُتفطِّرة السلِّيّة (Mycobacterium tuberculosis) التي تسبب الدرن، والكلوستريدم (Clostridium difficile)، وجاءت تلك النتائج لتقول إن معظم الأدوية الجديدة -43 من 51 مضادا حيويا تمت دراستها- التي تتجهز الآن في المعامل ليست إلا فروعا من مجموعات أخرى موجودة بالفعل وليست من طراز جديد، كما أنها تمثل حلولا قصيرة الأمد للمشكلات الحالية، بينما مثلّت المجموعة الباقية إمكانية لإيجاد حلول مستقبلية.
لم تعد هناك مضادات حيوية جديدة
وقد كان ذلك متوقعا ومرصودا قبل سنوات عدة، بالطبع نعرف أنه حينما نحاول صناعة دواء جديد فنحن نحتاج مدة ثلاث إلى ست سنوات من البحث العلمي وتطويره حول اختيار المادة الفعالة من بين آلاف أخرى موضوعة كاحتمالات، ثم تحديد أي من تلك المواد سوف نبدأ باستخدامه في التجارب الأولية، بعد ذلك سوف نحتاج لمدة تقترب من العام من أجل عمل الاختبارات الكيميائية الأولية والتجريب على الحيوانات، يحتاج التجريب الحذر على البشر لحوالي سبع سنوات، ونحتاج بعد إطلاق الدواء لسنتين من أجل رصد تطور استجابة البشر لهذا الدواء، ما يعني أن مادة فعّالة واحدة، كالبراسيتامول الموجود في قرص “دوليبران”، يحتاج لما يقترب من عشر سنوات لكي يصل إلى يديك.
وهذا ما أكدته أزمة “فيروس كورونا” المستجدة، حيث بدأ الحديث في الأوساط العلمية وفي أوساط المختبرات عن آجال زمنية طويلة تتراوح ما بين عام وعام ونصف للتوصل للقاح، ناهيك عن شهور أو أعوام أخرى لإنتاجه.
وما يبرر السرعة الشديدة في اكتشاف مضادات حيوية جديدة خلال العصر الذهبي للمضادات الحيوية، من الأربعينيات إلى السبعينيات، هو أنها استخرجت من تلك الكائنات الدقيقة نفسها، حيث تم عزل البكتيريا والفطريات من التربة والنباتات ثم زراعتها في المعامل وإنتاجها على نطاق واسع.
إن ما اكتشفته البشرية لم يكن إلا طريقة تلك الكائنات في الدفاع ضد بعضها البعض، والمشكلة هي أننا الآن لا نجد أيا من تلك المنتجات في نفس الأماكن التي بحثنا فيها من قبل، لقد نفدت بكل بساطة، وبات علينا أن نبدأ من جديد في خطط بحث علمي مختلفة ومبتكرة ذات علاقة بمركبات مختلفة كالبروبيوتيك واللايسينات والأجسام المضادة وتطوير الأمصال.
لكن رغم ذلك كله كان من الممكن للبحث العلمي أن يلتقط خيطا ربما أو اثنين للبدء فيه خلال ثلاثين عاما مضت، لكن هناك ثلاثة أسباب أخرى رئيسة تعد ربما هي مركز المشكلات العلمية التي تواجه ابتكارنا لمضادات حيوية جديدة، أولها هو توجه شركات الأدوية الكبرى لاستثمار الجهد العلمي والمادي الخاص بها في سبيل تطوير أدوية أخرى تتعلق بأمراض مزمنة كالضغط والسكري، تلك التي يستمر المريض في تعاطي أدويتها طوال عمره تقريبا ما يعني تأمين دخل متصاعد من خلال انتشارها، كما أن تلك الأمراض لا تطور أية مقاومة تضطر الشركة بين الحين والآخر للمخاطرة بالاستثمار في تطويرها من جديد، أضف إلى ذلك أن المضادات الحيوية الجديدة لا تدخل غالبا في الاستخدام مباشرة، بل توضع جانبا كملجأ أخير حينما تضرب البكتيريا المقاومة المرضى.
يجعل ذلك من بذل الجهد في تصنيع تلك المضادات الحيوية الجديدة هو فرصة متوترة للغاية أمام فئات أخرى من الأدوية التي تقع ضمن حدود الأمان في الأرباح والتوقعات المستقبلية عنها، يشبه الأمر أن تكون شركة إنتاج هوليوودية ضخمة، لن تغامر بالطبع في الاستثمار بفكرة جديدة لا تتسبب بربح مؤكد، لكنك سوف تستثمر الكثير بسهولة في صنع الجزء الثاني، الثالث، والثامن، من فيلم سابق ناجح.
أضف إلى ذلك أن الأعباء التنظيمية والاحتياجات المادية لإنشاء خطوط بحث علمي وإنتاج للمضادات الحيوية بكل ما تتطلبه من أنواع خاصة من التجارب العلمية والحاجة لوضع احتياطات إضافية تتعلق بالآليات المستخدمة لم تمكّن أبدا الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم من المنافسة في سوق هذا النوع من البحث، وإلى جانب المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها حينما تستثمر في ابتكار وإنتاج المضادات الحيوية دون غيرها كأدوية الضغط والسكري، تركت تلك الشركات المضادات الحيوية تماما بحيث أصبحت كيانات محددة فقط هي من يتمكن من تحقيق تلك المتطلبات.
ثم، ثالثا، يمكن أن نضيف إلى ذلك كله أن جزءا ضخما من الاستثمار المتعلق بإنتاج الأدوية قد التفت للابتكارات الجديدة المتعلقة بالعلاجات الجينية، والبيولوجيا التخليقية، وهندسة النانو واستخداماتها في عوالم تصنيع هيئات دوائية جديدة مختلفة عن التي نعرفها، لكن المشكلة هنا هي أن هذا النوع من الاستثمار لم يؤت ثماره الواضحة بعد، فتسبب ذلك -مع الأسباب الأخرى- في فجوة عمرها 30 سنة إلى الآن توقف تقريبا خلالها إنتاج مضادات حيوية جديدة، يمكن لنا هنا أن نقارن ذلك بالفترة بين الأربعينيات والسبعينيات (أربع عشرة فئة جديدة من المضادات الحيوية).
كيف نخلق الفيروس أو البكتيريا الخارقة
من الجهة الأخرى ما زلنا نواجه أزمة إضافية تتعلق بنمط استخدامنا كبشر للمضادات الحيوية، فإلى جانب عدم قدرتنا على تطوير مضادات حيوية جديدة، نحن أيضا نساعد حاليا في خلق البكتيريا الخارقة (Superbug) التي سوف تقاوم كل مضاداتنا الحيوية التي نعرفها، تأملوا كيف استطاع فيروس “كورونا” مع الفارق طبعا بينه وبين البكتيريا، تطوير نفسه من 2003 إلى اليوم ليصبح أكثر فتكا وشراسة. لقد أصبح قادرا على اختراق المناعة البشرية أكثر ولم يعد حتى الشباب قادرين على التصدي له.
هناك عدة مشكلات فرعية تتعلق بهذا النطاق، ومنها انتشار استهلاك المضادات الحيوية، فمثلا هناك دائما رقم أكبر من 50% من سكان دولة ما يعتقد أنه يجب أن يوصف المضاد الحيوي له أو لطفله في حالات بسيطة كنزلات البرد.
ما يزيد الضرر هنا هو أن هذا الضغط يؤثر بالفعل على الأطباء لوصف مضادات حيوية لمرضاهم من الأطفال والكبار، ما يتسبب في سوء استخدام عالمي للمضادات الحيوية، بل إنه في كثير من الحالات، ومن أجل الحصول على سمعة حسنة بين الناس كطبيب ماهر، يلجأ الكثير من الأطباء لتجاوز الآليات التشخيصية المعقدة ويقوم بوصف “تشكيلة” من المضادات الحيوية بحيث إن أفلت أحدهم الهدف فيمكن للآخر أن يصيبه.
بالإضافة إلى ذلك فإن الضغط على الأطباء من قبل الشركات المروجة للمضادات الحيوية عن طريق الحوافز المادية وغير المادية يدفع بالبعض إلى وصف مضادات حيوية في حالات قد لا تحتاجها، نزلات البرد العادية كنموذج رئيس، حتى إن 98% من الأطفال الذين يذهبون إلى المستشفيات في الصين يتلقون مضادات حيوية للبرد العادي.
هل يستسلم العالم للفيروسات؟
ليس من المبالغة إذا القول بأننا بالفعل بلغنا مرحلة جديدة بدأت تختفي فيها المضادات الحيوية، لكي نفهم ذلك دعنا نتأمل خبرا أثار الانتباه بشدة في أواخر العام الفائت عن مواطنة أميركية ماتت بسبب أنها أصيبت ببكتيريا من النوع إنتيروبكتيريا (Enterobacteriaceae) ظهر أنها مقاومة لكل المضادات الحيوية، نعم إنها كما سمعت، كل أنواع المضادات الحيوية، بحيث أصبح من غير الممكن أمام الأطباء فعل أي شيء سوى تركها تموت. يذكرنا ذلك بالاكتشاف المدوي في 2015 للجينات “mcr-1″ و”mcr-2” المقاومة للكوليستين12، واحد من المضادات الحيوية القليلة التي يبقيها الأطباء كخط دفاع نهائي أمام أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الأخرى التي تهدد حياة المرضى.
في أوائل العام الحالي أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمة باثني عشر نوعا من البكتيريا التي أصبحت تهدد البشرية بشكل مباشر بسبب تطويرها للمقاومة ضد أقوى مضاداتنا الحيوية، هناك 700 ألف شخص يموتون سنويا بسبب تلك البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مع توقعات أن يصل العدد إلى 10 ملايين شخص سنويا في سنة 2050 إذا استمر الوضع كما هو عليه، بدون المضادات الحيوية نحن كائنات غاية في الضعف، تخيل أن يصبح الالتهاب الرئوي مرضا قاتلا بنسبة 100%، أن يصبح التهاب اللوزتين، الإسهال، النزلات المعوية، الإصابات البكتيرية المصاحبة لنزلات البرد، هي أمراض قاتلة إذا أصابت أحدهم فسوف يموت حتما، ألا تتمكن من الخضوع لعملية استئصال زائدة دودية لأنه لا يوجد مضاد حيوي واحد يقيك من الإصابة ببكتيريا قاتلة في غرفة العمليات، لكن.. هل هذا يعني أننا حتما خسرنا المعركة أمام البكتيريا؟
ربما، لكن هناك حاليا تحركات جادة واسعة النطاق للحد من المشكلات التي تواجهنا في حربنا ضد البكتيريا، في بريطانيا تتحدث رئاسة الوزراء عن خطط جديدة لمواجهة تلك البكتيريا الخارقة وتطوير مراكز البحث العلمي الخاصة بالمقاومة ضدها، أما عن الاتحاد الأوروبي فقد أطلق مبادرة بقيمة تقترب من مليار دولار لدعم وتوجيه البحث العلمي ناحية اكتشاف مضادات حيوية جديدة، في الولايات المتحدة أنفقت الهيئة القومية للصحة ما مقدارة 5.6 مليار دولار من أجل البحث العلمي الخاص بابتكار مضادات حيوية جديدة، مما جعله ثاني أكبر إنفاق لمؤسسة صحية بعد الإنفاق على السرطان.
في الجهة المقابلة وضعت منظمة الصحة العالمية خطة عمل واضحة بمؤتمرها الثامن والستين في 2015 تضمنت رفع درجة وعي سكان العالم بمعنى مقاومة المضادات الحيوية، وسوء استخدام تلك الأدوية، كذلك خفض كم الإصابة الممكنة بالبكتيريا خاصة الأنواع الأكثر خطورة منها، وأيضا دفع الوضع الاقتصادي الخاص بتصنيع المضادات الحيوية وتحسين سوق العمل الخاص به عبر خلق دورات جديدة لرأس المال به.
إن البكتيريا من أوائل الكائنات ظهورا على سطح هذا الكوكب، أعدادها لا يمكن تخيلها، جسمك نفسه يحتوي على عدد من البكتيريا أكثر من عدد خلاياه، تطورت تلك الكائنات وتنوعت واجتازت اختبارات طبيعية قاسية غاية في العنف وعاشت على مدى مليارات السنين، كان أحد تلك الاختبارات هو المضادات الحيوية التي ابتكرها البشر، والآن بينما هي عبر تطورها تجد حلولا سريعة وحاسمة لمقاومة تلك الأسلحة نقف نحن بلا سلاح جديد أمام ذلك العدو الأقوى في تاريخنا، يكمن الحل فقط -كما يبدو- في شيء واحد، أن نصبح مثل البكتيريا، أن نقف يدا واحدة في كل مكان ضد عدونا المشترك، أن نمرر الوعي بالقضية إلى أصدقائنا وأقربائنا والعالم كله، أن تتدخل الدول والحكومات وتتشارك المعرفة فيما بينها دون أية أغراض سياسية، وأن تتنازل الشركات الضخمة عابرة الجنسيات عن هدف الربح فقط إلى هدف آخر مهم، إنه بقاؤنا.