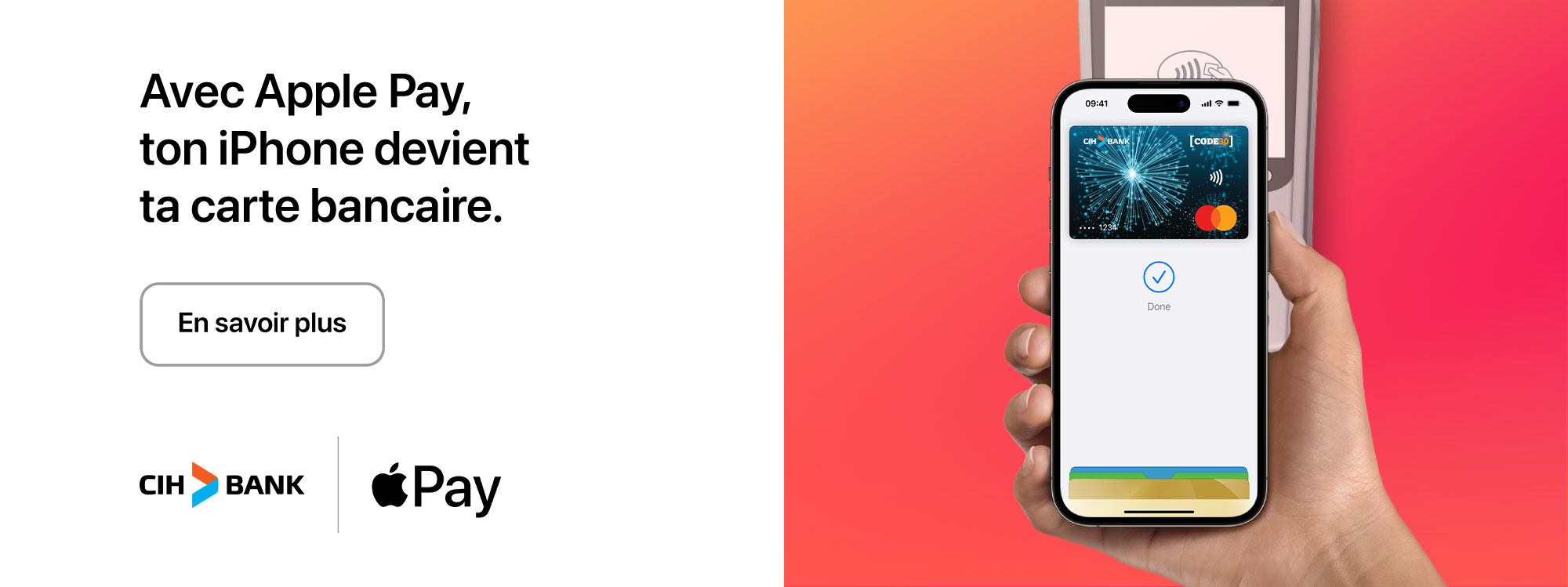الحروب الدولية.. من الصواريخ إلى الفيروسات

الرباط اليوم
يبدوا أن الفيروسات ستعوض الصواريخ، فلم يعد شبح الحرب النووية أو النترونية واقعيا، فالعولمة الاقتصادية وتشابك المصالح وصعود قوى عالمية جديدة خلقت توازنا جديدا أدخل العالم في نوع من الاستقرار المفروض. لكن الحرب البيولوجية دخلت حيز التجريب منذ فترة ليست بالقصيرة، وقد دفعت بعض الدول ثمن هذه الحرب بجائحات وبائية بأمراض فيروسية مختلفة ومختلقة: أنفلونزا الطيور، أنفلونزا الخنازير، فيروس إيبولا، فيروس زيكا وأخيرا فيروس كورونا القاتل. وفي ظل التقدم الهائل الذي يعرفه المجال الطبي في العالم يبدو الحديث عن انفلاتات وحالات وبائية غير مدبرة أمرا مستبعدا. إنها حرب بيولوجية غير معلنة بدأت تجربتها مع إيبولا في إفريقيا ووصلت اليوم إلى الصين.
لكن تحويل الأمراض والفيروسات والعدوى إلى سلاح قاتل لأغراض استعمارية أو عسكرية ليس مسألة مستجدة في تاريخ البشرية، إنه جزء لا يتجزأ من صراعات العالم الحديث الذي أعقب اكتشاف القارة الأمريكية وانطلاق التوسع الإمبريالي الأوربي عبر أرجاء العالم. لقد كتب هوارد سيمبسون في كتابه “دور الأمراض في التاريخ الأمريكي” قائلا “إن المستعمرين الإنجليز لم يجتاحوا أمريكا بفضل عبقريتهم العسكرية أو دوافعهم الدينية أو طموحاتهم أو وحشيتهم، بل بسبب حربهم الجرثومية التي لم يعرف لها تاريخ الإنسانية مثيلًا”.
فرضية التسريب والخطأ
هذا ما يسمى في لغة العصر الحديث بالأسلحة البيولوجية التي يتم تطويرها في أكبر المختبرات العلمية العسكرية. لكن هل يمكن أن تتغير الأهداف والغايات من توظيف الأمراض والفيروسات إلى مطامح اقتصادية ومالية؟ كثير من أنصار التحري والبحث في تاريخ المختبرات الطبية وأسرارها لا يترددون في اتهامها باستغلال التطور العلمي الهائل الذي تم تحقيقه في اكتشاف عالم الفيروسات من أجل زيادة فرص النمو والربح في قطاع يعتبر من القطاعات الواعدة اليوم في مجال الاستثمار.
بينما تسابق الصين الزمن من أجل محاصرة فيروس كورونا في منطقة ووهان والقضاء عليه، تتنامى الافتراضات بخصوص الأسباب الحقيقية لانتشاره ومصدره. ويُعتقد، على نطاق واسع، أن سلالات الفيروسات التي سببت انتشار وبائي (سارس) و(ميرس)، والوباء الحالي لم تنشأ عند البشر بل عند الحيوانات. ولحسن الحظ، يندر أن تنتقل الفيروسات الخطرة التي تنقلها بعض الحيوانات إلى البشر. وتبدأ الخطورة عادة بطفرة وراثية غير طبيعية إذ يجب أن تتغير طبيعة الفيروس بطريقة ما في العادة لكي يحصل على فرصة النمو والانتشار بشكل جيد في محيطه الجديد.
فكيف تحصل هذه الطفرات ومن المسؤول عنها؟ بالإضافة إلى الظروف الطبيعية غير الواضحة يعتقد بشكل كبير أن جل الجائحات الوبائية التي أصابت العالم في السنوات الأخيرة كانت بسبب تسرب للفيروسات المطورة جينيا من المختبرات الطبية في بعض البلدان المتقدمة. وقد أكدت بعض التقارير البريطانية مؤخرا أن فيروس كورونا الذي يضرب إقليم ووهان في الصين يمكن أن يكون نتيجة أعمال بحث وتطوير في أحد المختبرات في المنطقة وأنه ربما تسرب مع أحد العاملين في هذه المختبرات لينتقل إلى عامة المواطنين عن طريق العدوى.
فرضية الحرب البيولوجية
لكن فرضية الحرب البيولوجية التي تحف انتشار فيروس كورونا في الصين تشير إلى أن الأمر لم يكن مجرد خطأ أدى إلى تسرب الفيروس وإنما إلى نشره بفعل فاعل. هذا ما ذكره على سبيل المثال تقرير لـ”منظمة العدل والتنمية في الشرق الأوسط”، الذي أكد أن فيروس “كورونا الجديد” في الصين، “تم تصنيعه واختلاقه في مختبرات طبية سرية في أوروبا”. ويشير المتحدث باسم المنظمة غير الحكومية، زيدان القنائي، في تصريح صحفي إلى إن دوافع إعداد التقرير المذكور، جاءت “بعد اكتشافهم لمختبرات سرية في أوروبا، تعمل على تصنيع فيروسات، يتم توظيفها في حروب بيولوجية ضد دول بعينها”.
ولتكتمل خيوط المؤامرة حسب هذا التقرير فإن شركات أدوية كبيرة ستعلن بعد أن يقتل الفيروس عددا هائلا من البشر، عن لقاح مناسب له، وذلك كخطة لتضخيم أرباحها من لقاحه. وعن سبب ظهور الفيروس في الصين تحديدا، هذه المرة، يعتبر التقرير أن ذلك سيسرع في انتشار واسع للفيروس، نظرا للكثافة السكانية الكبيرة في الصين، والتي تقدر بالملايين. وتوقع أن ينتقل الفيروس الجديد، إلى الهند أيضا، مع احتمال أن يقتل أعدادا كبيرة، بسبب ظاهرة التغير المناخي وتلوث الهواء، التي ستساعد في انتشار الفيروس هناك.
تزداد فرضية الحرب البيولوجية المقصودة التي تقف وراءها أطماع شركات اللقاحات والأدوية قوة بسبب الإمكانية العلمية الظاهرة للتلاعب في فيروسات موجودة في الطبيعة. فمن المعروف أنه ليس ممكنا بعد اختلاق فيروسات من العدم لكن من الثابت أنه من الممكن تطوير الفيروسات الموجودة وتعديلها جينيا لتصبح أكثر قابلية وقدرة على مقاومة الأدوية والعلاجات.
وفيروس “كورونا” يعرف أيضا بفيروس “كورونا الشرق الأوسط”، وهو واحد من الفيروسات الزكامية الحادة. ويرجع اكتشافه لطبيب مصري متخصص في علم الفيروسات في “جدة”، السعودية، وهو محمد علي زكريا، الذي أعلن في 24 سبتمبر 2012 عن اكتشاف فيروس متطور وأعطي له رمز “MERS-CoV“. وهو فيروس شبيه على حد كبير بالزكام الطبيعي الموسمي، ويتشابه معه في الأعراض، إلا أن خطورته تكمن في تطوره إلى ما يعرف بالالتهاب التنفسي الحاد، المصحوب بالحمى والسعال وصعوبة التنفس.
اللقاحات..الدجاجة التي تبيض ذهبا
يرتقب أن يتأكد في الأيام القليلة الماضية إعلان لقاح جديد خاص بفيروس كورونا من طرف بعض المختبرات الصيدلية العالمية. وهو ما سيمثل بالنسبة لها فرصة نمو وتعزيز لقدراتها الربحية والمالية بشكل كبير بعد حالة الخوف والهلع التي خلقها انتشار الفيروس في إقليم ووهان الصيني وإعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ بسبب إمكان تسرب العدوى خارج الصين. فقد تحولت الفيروسات المتحكم فيها إلى حافز اقتصادي واستثماري هائل يدفع الملايين من سكان العالم اليوم إلى استهلاك المزيد من اللقاحات والأمصال للوقاية من الأمراض التي تغزو أخبارها وسائل الإعلام في عصر العولمة؟ في الواقع لا يمكن للمختبرات الطبية والصيدلية أن تقاوم إغراء الثروات الهائلة التي يعد بها هذا القطاع.
لقد أدركت المختبرات أن الرهان على اللقاحات هو المنقذ من الأزمة التي ضربتها في 2008 لأنها ببساطة ليست قابلة للتجنيس قانونيا وحتى علميا وبيولوجيا. وهنا بدأت الطفرة. لقد حقق سوق اللقاحات العالمي معدل زيادة في مبيعاتها بين 2011 و2014 بلغ 24 بالمائة. وبدأت التوقعات المبشرة في تضع نصب عينيها العام 2025 حيث يرتقب أن يتضاعف رقم معاملاتها مرتين ونصف ليصل إلى 80 مليار دولار. وفي نظر الكثير من المراقبين للشأن الصحي والعلمي فإن هذه الأرقام الضخمة قد تمثل إغراء قويا لهذه المختبرات من أجل دفع سكان العالم وخصوصا في البلدان الصاعدة حيث ثقافة التلقيح في طور النمو إلى المزيد من استهلاك الأمصال واللقاحات.
تجارب أم زراعة؟
نظرية المؤامرة تعتبر في موضوع اللقاحات والمختبرات رأيا شائعا بل أحيانا قناعة لدى الكثير من المواطنين. الحملات الإعلانية الضخمة والدراسات التي لا تكاد تنتهي حول جدوى اللقاحات وكذا المتابعة الإعلامية الكبيرة للحالات الوبائية التي تصيب رقعة ما كلها عوامل ضغط تؤرق الوعي البشري وتجعل السكان يتساءلون عن ما وراء كل هذا الحشد الذي لا يمكن أن يقتصر فقط على خلق وعي صحي وقائي بل إنه يترافق مع أغراض تجارية صرفة. وتثبت بعض الوقائع التاريخية أن المختبرات الطبية لم تكن دائما محصنة ضد الأخطاء القاتلة التي تؤدي إلى نشر أمراض أو فيروسات قاتلة تعقبها حملات بيع وترويج للقاحات وأمصال فعالة.
هذا ما يسمى في تاريخ المختبرات بتسربات المسببات المرضية والفيروسية التي تفلت من أجهزة البحث والدراسة والثلاجات ومن بين أيدي الباحثين لتخرج إلى الفضاء العمومي وتتجول وتنتقل بين الأفراد. وقع ذلك التسرب مثلا في حالة فيروس أنفلونزا الخنازير في 1976 بولاية نيوجيرزي الأمريكية، ثم تسرب مجددا في 1977 بالاتحاد السوفياتي. وقد تأكدت عملية التسرب هذه في 2010 بناء على دراسة علمية مضبوطة أكدت أن هذه الفيروسات التي خرجت إلى الفضاء العام في السبعينيات كان مصدرها مختبرات طبية كانت تعمل على إيجاد لقاح لفيروس أنفلونزا الخنازير.
لكن قبل هذا التاريخ كان هناك تسرب آخر لا يقل شهرة. إنه تسرب الجدري. ولسخرية القدر فإن هذا التسرب حصل في بريطانيا التي سبق أن وظفت هذا الفيروس القاتل لإخضاع الهنود الحمر. فقد تأكد علميا أن الحالات الثمانين من الجدري التي سجلتها البلاد في 1978 وتسببت في ثلاثة وفيات كانت تسربات من مختبرين مختلفين. لكن أقوى التسربات التي وقعت في الألفية الثالثة هي التي مست 29 بلدا بعد أن غزاها فيروس مرض “سارس” والذي تسبب في أكثر من 700 حالة وفاة. كانت حالة سارس أخطر الحالات بسبب عدم توفر لقاح ضد هذا الفيروس القاتل وقد ثبت لاحقا أن انتشاره سجل بسبب ست حالات تسرب في سنغافورة والتايوان والصين. وإضافة إلى التقصير الواضح الذي ينسب إلى هذه المختبرات سواء فيما يتعلق بإجراءات السلامة أو بحماية العاملين أو بتوفير المعدات التقنية اللازمة، فإن المثير للقلق في علاقة المختبرات بانتشار الفيروسات القاتلة التي تحتاج إلى لقاحات وأمصال هو أن هذه المختبرات لجأت في مرات عديدة إلى تمويل أبحاث تقوي هذه الفيروسات وتجعلها أكثر قدرة على مقاومة العلاجات والعيش في بيئات عدوانية. لقد كانت هذه الأبحاث ذات أغراض تجريبية لكنها تطرح على مستوى الأخلاقيات العلمية إشكالا كبيرا. على سبيل المثال تبين أن المختبرات الطبية العالمية ساهمت في تمويل أبحاث تهم فيروس أنفلونزا الطيور من أجل تقويته وجعله قادرا على المقاومة. والذي يثير التساؤلات في هذه التجربة أنها تمت في مختبرات جامعية تقع في وسط أحياء تعج بالسكان مما يجعل خطر التسرب ثم الانتشار عاليا جدا. إن عدم اتخاذ المختبرات للأ}راءات الحمائية الضرورية يعتبر في نظر الكثيرين تقصيرا مقصودا الهدف منه استمرار حياة بعض الفيروسات التي كان المفترض أن تنتهي بالقضاء عليها نهائيا لكنها تكتسب حياة جديدة عن طريق المختبرات والتجارب كما حدث مع مرض الجدري. نحن إذن أمام زراعة مشبوهة بدل الحديث عن تجارب علمية صرفة.